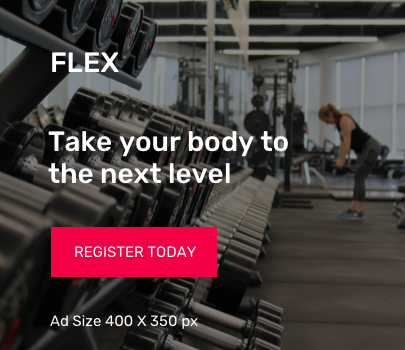كان خُلُقه القرآن
وُلد قدوتنا عليه الصلاة والسلام يتيمًا، ثم مالبث إلا أن فقد والده عبد الله. وما إن بدأت طفولته حتى رحلت والدته آمنة، وهو لم يزل في السابعة من عمره. طفلٌ في مهبّ الأقدار، أعزّ ما يملك يتساقط من حوله واحدًا تلو الآخر. تكفّله جدّه عبد المطلب، فكان له سندًا، لكنه ما لبث أن رحل أيضًا حين بلغ الثامنة. ثم جاءه عمه أبو طالب، فضمه إليه، وآثره على أولاده، وحماه حتى بلغ الأربعين، وما كان له بعد الله من نصير سواه.
ثم ماذا؟ تزوج خديجة رضي الله عنها في الخامسة والعشرين، فوجد فيها السكن والمأوى، وأحبها حبًّا شديدًا، لكن الدنيا لم تتركه طويلًا في واحة الطمأنينة. فقد مات عمه أبو طالب، وتبعته خديجة في أيام قليلة، فاشتد الحزن عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى سُمّي ذلك العام عام الحزن. حينها تجاسرت عليه قريش، وتكالبوا عليه وقد فقد أهله وعشيرته، وأرادوا قتله لا مجرد إخراجه، لكن كان معه ما لم يكن لغيره، كان معه الوحي المستمد من السماء، النور الذي لا يطفئه ظلم، والسلاح الذي لا يحتاج إلى عدد أو مدد.
وهل كانت هذه إلا قطرة من محيط البلاء الذي أصابه؟ ومع ذلك، لم يهن ولم يضعف، لأن القرآن كان يتنزل عليه، يغذيه بالصبر، يثبّت قلبه، ويقوّيه.
كان القرآن حياته، وكان يمشي على الأرض ويخبر الأقوام عن نور الله، بأن نعبده ولانشرك به شيئا.
فما بالنا اليوم نخور تحت أول اختبار؟ وتهوي أرواحنا عند أول عثرة؟ ولماذا سقطت المجتمعات في الجهل والضلال؟ ما ضعفنا إلا لأننا لم نأخذ هذا النور بحقّه، ولم نتمسك به كما تمسّك أهل السلف. إن أردنا الحق، والبصيرة، والثبات، فلن يكون إلا بالقرآن، فهو سلاحنا، وعلمنا، والنور الذي لا يُحجب، والطريق الذي لا يضل سالكه كما قال عز وجل ﴿وَأَنَّ هذا صِراطي مُستَقيمًا فَاتَّبِعوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبيلِهِ ذلِكُم وَصّاكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَتَّقونَ﴾.
فاللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، اللهم اجعله شفيعاً لنا ، وشاهداً لنا لا شاهداً علينا
الكاتبة: رحاب الدوسري
المدققة: غدي العصيلي